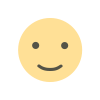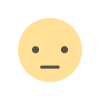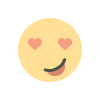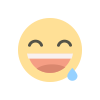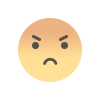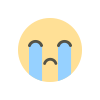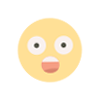الجزء الاول من الحوار الذي أجرته الباحثة والإعلامية اللبنانية أورنيلا سكر مع الدكتورة الباحثة كريمة نور العيساوي

فاس تيفي 1
أجرت الباحثة والإعلامية اللبنانية أورنيلا سكر مع الدكتورة الباحثة كريمة نور العيساوي حوارا في شهر يوليوز 2020، فيما يلي الجزء الأول من الحوار:
س١ الإعلامية أورنيلا سكر: ما هو علم مقارنة الأديان، وأين تتجلى أهميته؟
ج ١ كريمة نور عيساوي : علم الأديان أو تاريخ الأديان أو مقارنة الأديان هو علم يعنى بدراسة الأديان الأُخرى باعتبارها حقائق علمية وظواهر تستحق البحث اعتمادا على منهجٍ علميٍّ رصينٍ، يصنف مادَّتها ويصفها بحياديَّةٍ تامةٍ ويستخلص معانيها. علم تاريخ الأديان علم جديد، لا يتعدى عمره في الغرب مائة سنة وربما أقل، وقد نشأ هذا العلم بوصفه حقلا معرفيا مستقلاً وعلماً غير طائفي ولا ديني،وتراوحت الأسماء التي تُطلق عليه ما بين علم مقارنة الأديان وعلم الأديان وعلم تاريخ الأديان. ولكل اسم من هذه الأسماء دواعيه ومبرراته. ففي إنجلترا وخصوصا في جامعة أكسفورد أطلق عليه اسم علم مقارنة الأديان Comparative Religions على يد باحث شهير هو ماكس ميللر Max Miller الذي أسند إليه تدريس هذه المادة وذلك سنة 1896. وقد شاع في ألمانيا اسم آخر هو علم الأديان Religions Wissenschafft. ولعل في توظيف الألمان لهذا الاسم دلالة خاصة، فقد كان علم الأديان، كما هو معلوم، محتكرا من قبل الكنيسة التي عندما مارست البحث في الأديان الأخرى) المسيحية واليهودية( لم تكن تتسم بالموضوعية، فجاء هذا الاسم أي علم الأديان كإشارة إلى أن ما كانت تقوم به الكنيسة ليس علما للأديان ، وأن الهدف من هذا العلم يتمثل في دراسة المادة الدينية بشكل علمي وبكل موضوعية. أما اسم تاريخ الأديان فهو ترجمة عن الإنجليزية والفرنسية، ويُعتبر الفرنسيون هم أول من أطلقوا عليه هذا الاسم. وقد نقله الأمريكان عن الفرنسيين سنة 1952، خاصة عندما استقدموا مارسيا إلياد Eliade، أستاذ تاريخ الأديان في جامعة السوربون بباريس، وعينوه أستاذا بجامعة شيكاغو في كلية اللاهوت، فأنشأ هذا الأخير مجلة أطلق عليها عنوان تاريخ الأديان History of Religion ومنذ ذلك الوقت شاع هذا الاسم في الأوساط الأكاديمية الأنجلوساكسونية.
جملة القول إنَّ هذا العلم، على اختلاف مسمياتِه، يدور حول وصفِ الأديان وصفا علميا دقيقا متسما بالموضوعية، وإلى جانب اهتمامه بمسيرة الأديان في التاريخ، يَعمدُ أيضا إلى مقارنة ظواهرها الأساسيَّة دون إغفال أي عنصر من العناصر المكونة لهذه التجربة الدينية أو تلك. وفي هذا السياق يرى محمد خليفة حسن في كاتبه تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة، "أن علم تاريخ الأديان من العلوم الأساسية في التراث العلمي الإسلامي، بل هو علم إسلامي مهمل إذ لم يلق عناية كافية من الباحثين المعاصرين، خاصة فيما يتعلق بالجانب المنهجي الذي طوره علماء تاريخ الأديان في القرون الأولى للهجرة، ..ونظرا لجهل الغرب أو تعصبه فقد اعتبر هذا العلم علما غربيا في منهجه ومضمونه حيث تجاهل مؤرخو هذا العلم في الغرب الجهود الإسلامية في مجال دراسة الأديان ومقارنتها، بالرغم من معرفتهم الجيدة بالكثير من الأعمال الإسلامية في هذا المجال"
وليس غريباً أن يكون تاريخ الأديان، في صورته الغربية قد تأسس على كتابات العلماء المسلمين التي ترجمت منذ وقت مبكر إلى العديد من اللغات الأوروبية، مما أتاح الفرصة أمام علماء الغرب المتخصصين، الذين اهتموا بدراسة المادة الدينية والفرق والمذاهب، الاطلاع على مناهج المسلمين في دراسة الأديان والملل الأخرى. وحسبنا هنا الاستشهاد بقول الشهرستاني أحد كبار مؤرخي الأديان " اعْلم أنَّ العربَ الجاهليَّة كانت على ثلاثةِ أنواعٍ من العلومِ: أَحدها علمُ الأنسابِ والتواريخِ والأديانِ" . والفكرة نفسها نستشفها من رسائل إخوان الصفا في قولهم: " واعْلم يَا أخِي أنَّ العلمَ علمانِ: علمُ الأبدانِ وعِلمُ الأديان" .
ما هو تأثيرها على المجتمعات العربية وبشكل خاص عند الطلبة وتفاعلهم مع هذه الدراسات؟
للأسف الشديد هناك عوائق تحول دون تأسيس علم مقارنة الأديان في العالم العربي والإسلامي. ويمكن أن نجملها في العناصر الآتية:
عدم فهم طبيعة الرسالة الإسلامية. ومن ثم نجد أن الكثيرين، يلوحون في وجه كل من يدعو إلى تأسيس هذا العلم القديم الجديد… لماذا ندرس الأديان الأخرى؟ أو لم يرد في القرآن الكريم: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (سورة آل عمران، الآية 19). «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (سورة آل عمران، الآية 85). وما الداعي إلى إهدار الوقت في دراسة أديان ما دام القرآن الكريم روى بالتفصيل عن أهلها وعن عقائدهم ومذاهبهم؟ ثم سيكون من غير المفيد أن ننفق الوقت والمال والجهد من أجل المقارنة بين الدين الحق والأديان الباطلة. ومن هنا نلمس لديهم نوعا من الحساسية اتجاه مفهوم المقارنة نفسه…، والتي لا تعني في نهاية المطاف سوى منهجا للبحث يسعى إلى البحث عن عناصر الاتفاق والاختلاف بين الأديان دون وجود أي نزعة نحو المفاضلة بينها. ويبدو المقبل على تدريس هذا العلم أو المتلقي له كأنهما يشاركان في تهمة الطعن في الإسلام. على الرغم من أننا ننبه دائما إلى ضرورة التمييز بين الذات والموضوع. فأنا كمسلم أو كمسيحي أو درزي لن يضيرني في شيء أن أدرس هذا العلم أو ذاك. وعلم مقارنة الأديان واحد من هذه العلوم التي تنتمي إلى فلك العلوم الإنسانية. أوروبا نفسها عاشت تجربة مماثلة. وكان للكنيسة موقف مناهض لنشأة هذا العلم، وحاربته في أول الأمر. غير أنها خضعت في نهاية المطاف إلى الأمر الواقع، وأصبحت لها أيضا كلياتها ومعاهدها التي تحاول التوفيق بين البعد اللاهوتي والدراسة العلمية للأديان. وقد يتحول علم مقارنة الأديان لدى البعض إلى واجهة لتصفية الحسابات مع الأديان الأخرى. ويسهم هذا الاتجاه في خلق أجيال من الشباب الذين يرفضون الآخر، والذين قد يتحولون إلى قنابل موقوتة. مع العلم أن الإسلام قدم صورا غير مسبوقة للتعايش بين الأديان والأعراق والثقافات. وليس سرا أن تكون الحضارة العربية الإسلامية كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا الحوار شاهدة على تأسيس هذا العلم لأول مرة في تاريخ البشرية. وربما يجهل الكثيرون أن الفضل في ذلك يعود إلى الجدل الديني الذي كان يدور بين العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود، وإلى المناظرات الدينية التي كانت تُعقد في قصر الخلفاء أو الأعيان. ولم يحل انتماء المناظرين إلى المسيحية دون الدفاع عنها، وإبداء اعتراضهم على الإسلام.
إن عدم التفاتنا إلى هذا التراث وتقاعسنا عن تحقيقه ودراسته والتعريف به هو الذي رسخ في الأذهان فكرة أن الإسلام دين عنف ودين إقصاء الآخر. وقد تكون للغرب يد في ذلك بسبب الصراع الحضاري بين الشرق والغرب. قد تكون الصورة التي رسمتها لعلم مقارنة الأديان سوداء. غير أن هذا لا يتعارض مع وجود تجارب فردية أو مؤسساتية هنا وهناك تحظى بشيء من المصداقية لأنها تحاول أن تقتفي في غياب تام للإمكانيات المادية والبشرية التجارب الغربية لكن دون أن تقطع صلتها بالتراث العربي الإسلامي. ومن المفارقات أننا نجد شبه قطيعة ما بين المؤتمرات الكبرى التي تعقد حاملة شعار حوار الأديان أو ما شابه ذلك، والتي تُنفق عليها أموال طائلة وبين التجارب الأكاديمية التي رأت النور في فضاء الجامعة.
لنكن صرحاء إن تأثير هذه التجارب لا يزال محدودا. وقد تتسع القاعدة تدريجيا إذا ما كتب لها الاستمرار. لكن ينبغي التأكيد على أن هذه الوضعية أحسن حالا من ذي قبل حيث كانت في وقت من الأوقات السيادة للفكر الاشتراكي وخطابه الإيديولوجي والصحوة الإسلامية وخطابها الدعوي. وكانا آنذاك يشتركان في عدائهما لهذا العلم وإن اختلفت الأسباب والمبررات. حدثت تحولات كثيرة في السنين الأخيرة. وقد نشعر بنوع من الارتياح لأن مصطلح علم مقارنة الأديان أصبح متداولا.
يتبع