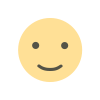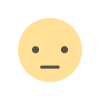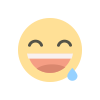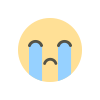"سيرة القلم" علاقتي بالسيد إركسون كانت عجيبة...
فاس تيفي1
بقلم الكاتب الدكتور هشام خلوق
في الحقيقة لست أدري...
هل أنا فعلا سعيد الحظ والطالع لأنني كنت شاهدا على تلك المرحلة؟
أم بطل العالم في الحظ السيء لأنني عايشت تلك المهزلة؟
فجأة وبدون مقدمات... اكتسحت الهواتف النقالة مدينة فاس وكامل البلاد، كما يكتسح الجراد المحصول...
خليط من شباب وشيّاب بل وحتى الأطفال تسابقوا لاقتناء الأجود منها. وبقدرة قادر لم تعد أزمة بالمغرب، وأصبح المال متوفرا، وصار الجميع يملك ما يشتري به الهاتف. ومع كل عرض جديد، يتسابق الحجيج تسابق المؤمنين على الأجر، ويصطفون بخشوع أمام أبواب الوكالات، اصطفاف المبشرين أمام أبواب الجنة.
ادخلوها بسلام..
هكذا استفقت ذات صباح لأجد الناس قد جنّت، واستعمر حديثها موضوع واحد. أي تأثير سحري لهذه الآلة الصغيرة، وأي جنون يأخذ من يفتحها. تملكني الهلع، ورأيت ممن حولي ما لم أره من قبل، وخفت على نفسي من أن أقع في نفس السحر. وقلت كيف سيكون حالنا مع فتنة أكبر...
كان سلوكا لا إراديا للقطيع، توجهه الشركة الراعية للربح السريع. وفي زمن قياسي صار من يستهلك هو نفسه سلعة تُستهلك (لكن أكثر الناس لا يعلمون).
المراهقون وما أدراك ما المراهقون...
تنافسوا في وضع الهاتف في الحزام، وهناك من وضع اثنتين. الأمر كان مضحكا ومبكيا في نفس الآن.
أما الرجال فآه لو تدرون...
صار حالهم غير الحال، أمر بجانب الرجل المهاب الجانب لأجده يشتكي من إزعاج المتصلين الذين يرنون ثم يقطعون، وكيف أنه من دهائه وذكائه يفتح الخط بسرعة قبل أن يقطعوا الاتصال ويضيع عليهم التعبئة. أنظر للحية الرجل وهو يتحدث وأقول:
ـ سبحان الله...
ومع كل تلك الصبيانية التي أصبحت وطنية، أصدرت القرار التالي:
ـ لا للهاتف...
حينها فقط أحسست أنني سيد قراري، وأنني استرجعت حريتي حتى قبل أن أفقدها، وأن كرامتي أكبر من أن أتتحول لسلعة رخيصة بقرار وقعه غيري...
استمرت مقاومتي لإغراء الآلة العجيبة، إلى أن جاء أوان سفر أختي الكبرى لكندا من أجل الدراسة، وبما أنني لا أملك هاتفا، تركت لي هاتفها ورقمه دون أن أطلبه...
ويكأنها وضعت بين يدي قنبلة موقوتة ثم رحلت...
صغير وأنيق، من نوع "سوني إركسون"، ألوانه جميلة، تتصدر دقنه خالة جميلة كتلك التي تزين وجوه الحسناوات. كان إغراء سيد إركسون كبيرا، والحقيقة أنني عشقته، لكن المبدأ انتصر، فحملته للرف وتناسيت وجوده.
مرت الأيام، وأعجبت بفتاة، فطلبت رقم هاتفي، ويقينها أنني أملك واحدا، واستغربتْ حين علمت أنني كائن بدائي بدون هاتف. تخيلت من نظرتها المستفهمة أنني بدون ملابس وبدون هوية...
ثم تعمقت العلاقة بيننا، فأصبحت أبحث بدافع الشوق على وسيلة للتواصل المستمر... ولم يكن أمامي من خيار غيره:
سيد إركسون...
تقدمت من الرف ونظرت للهاتف الأنيق، ثم ابتسمت وأخذته للشحن. ثم سلمته لها في لقائنا التالي، كي تريني طريقة استعماله. قلت لها وهي تشرح:
ـ اليوم فقط استسلمت للتكنولوجيا من أجلك...
فرحت واحمرت وجنتاها، فأكملت صادقا:
ـ أنت كوثر وأنا اليوم عنتر... هو ضحى بحياته وركب الخطر، وأنا ضحيت بما هو أكبر، موقفي من الهاتف...
بعدها أصبحت علاقتي بالسيد إركسون وطيدة جدا، ورغم تجدد الهواتف إلا أنني لم أغيره، وازداد إصراري عليه، إلى أن تعطل وأصبح غير قابل للإصلاح، فأقمت له جنازة نفسية حقيقية، استحضرت فيها ما عشناه سويا، ثم استبدلته مرغما بهاتف قدم لي هدية في وقت سابق.
وإلى اليوم لم أشتر لنفسي هاتفا قط، أستعمل فقط ما يتم إهداؤه لي أو الهواتف التي تسلمتها في العمل. ولا أنكر أنني اشتريت بعض الهواتف، لكنها لم تكن من أجلي، بل هدايا قدمتها لمن أعزهم...
ومهما طورت الشركات المتنافسة تكنولوجيا هواتفها وعددت وظائفها، فإن أعظم هاتف بالنسبة لي سيبقى دائما وأبدا:
"سيد إركسون"